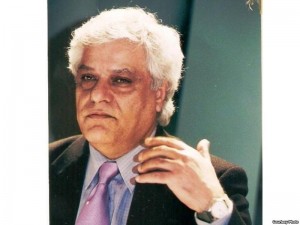في الطفولة كنا نلعب «عسكر وحرامية» وحين كبرنا اكتشفنا ان العسكر هم الحرامية. في اليفاعة هجانا غرباء لكثرة التابوات (التحريمات) في ثقافتنا. وعاب عليـنا كاتب مهجري انيق عجزنا عن نقد رجال الدين والعـسكر، وأيضاً (لدهشتي) الاطباء، او تحريم الخوض في مسائل الجنس.
اذكر غضبي من هذه «التهم الجائرة»، وكان ردنا مكاييل من التهكم على بذلته المكوية بعناية، وربطة عنقه المحبوكة من نسيج صوفي (بدل ان تكون ناعمة)، وحذائه اللماع الذي لم يتـلطخ بمياهنا الآسنة التي تجري في بالوعات مكشوفة (قبل بناء المجاري المطمورة). تحدثنا «عنه»، ولم نتحدث «عنا». لكن للأشياء عنادها الخاص، وهي لا تني تتهدم، وتسقـط بقوة الجاذبية فوق رؤوسنا. وكنا في المقابل نتخيل، رغماً عن نيوتن، انها تسقط بالمقلوب، الى اعلى. ما همّ ان نستنجد بخيال وولت ديزني، فنطير من الطابق العاشر الى الارض بخفة الريش، وأن ندفع صخرة هابطة بلمسة من ابهام لتعود الى القمة. مع ذلك توالت الأحـجار مـنهمرة مثـلما يـنهال البـرد في شـتاء جليدي.
وبينما كان الشباب الفتي يتداول قصائد ابي نواس وبشار بن برد العارية، ويقلّب اوراق «الروض العاطر»، و «رجوع الشيخ الى صباه»، الخليعة، كجزء مباح من ادب المجون، الموجود في كل الثقافات، كان بعض الادباء والكتاب يتعرض للسجن، او الطرد من العمل، لمجرد اثارة سؤال عن الموقف من الجنس في مقابلة مع طالبات جامعيات (حصل هذا مع الـشاعر والكاتب نبيل ياسين في عراق ايام زمان من بين مئات الحوادث).
وبالطبع، فإن حماة الاخلاق يشمّرون عن سواعدهم دفاعاً عن نقاء الشرف العربي (هل هناك شرف صيني ام مغولي؟). ويراد لنا بهذا الاعتقاد اننا شعب طاهر، نقي، نولد من غير «ليبيدو» فرويدي، وان الجنس عار معيب.
وما يصح على ايروس الماجن يصح على فيروس المحارب. فالمحاربون بناة الامة، وأوصياؤها. وهم بعد هذا وذاك «حراس الوطن»، و «حماة الديار»، يبنون الاوطان بـ «الجماجم والدم»، لا فرق إن كانت جماجم الأعداء، أو جماجم الاهل. ولا بأس ان مرق العسكر في انقلاب اهوج، فهناك انقلابات لتصحيح الانقلابات. وحين يُهزم العسكر في كل الحروب، فالمذنب هو «المؤامرة من برا»، او «المؤامرة» من جوا. وبيـنما ينهب ضـباط الميـرة والتمـويـن طـعام الجنود، ويبـيـعونـه عـلـناً في الاسواق، تلهج الاذاعة بـ «الجيـش سـور للـوطن». وهذا امـر طبـيعي، بل مـقبول، لأن حـامـي الـوطـن شـأن كل الفانين على الارض، بحاجة الى رزق للعـيـش. كـما ان من الطبيعي غض الطرف عن النهب والتصاهر مع اسـاطين المال، فلا يجوز ترك الخوذة في موقع اجتماعي ادنى. ومن الطبيعي ايضاً التغاضي عن استـبعاد الامـة، فالاسترقـاق هو خـدمة جـليـلة لـها. ولا فرق بين أمّة (بتـشديد الميم) او أمـَة (بـفتح الـميـم) حتى في اللغة سـوى شـدّة مبهـمة! لكن المراعاة واجبة من كل بد، فأولاء يضعون ارواحهم على اكـفهم في سـوح الوغـى، شأن بعـض اصحاب الـعمائم، الظاهرة، او المـستـترة، إخـواناً كـانوا ام اصـحاب تكفـير وهـجـرة.
فهؤلاء هم ايضاً حماة اوطان من نوع آخر، دروع اوطان فكرية. والمساس بأفكارهم حتى من باب الاسـتفسار والنقاش، مسـاس بـ «المقدس». فهم في عصمة دائمة، لا يبتغون من الدنيا (بعد الرواتب) شيئاً. ومن باب الكـفر والمـروق والـفسـوق ان تنظر في تلـســكوب لرؤية الهلال، فهذا علم باطل، ما دمت لا تـحمـلق في الـسـماء بالعين المجردة.
ها هنا نقف إزاء هؤلاء، أبطال الاخلاق، وأبطال الاوطان، وأبطال الأرواح، عاجزين عن التفوه بكلمة. فالرقيب كائن خرافي عملاق، له من الاذرع والعيون ما يفوق الوصف. فهو مثل إلهة الاغريق مـيدوزا، تحول كل من تبصره الى كتلة من حـجر. وهو مثل إله الاغريق جانوس، حارس الابواب، له عيون ترى الرائح والغادي، من كل الجهات الاربع، وفي كل جهة زوجان من العيون، يغمض واحدة عند النوم، وتبقى الثانية مفتوحة.
نعرف ان للرقيب العربي كل ذلك، وهو الآن، فوق ذلك، يمتلك اسلحة الضغط الناعم، تحريماً ومنعاً. ولا تنخدعوا بالربيع العربي، فالرقابة اشطر من ان تسفر عن نفسها، فهي لم تعد قابعة في اروقة الحكومات، بل مزروعة في قـلب المؤسسات الاهلية، في دماغ موظف يعدد اياماً ويقبض راتباً. وحتى نصل الى تحررنا في التفكير، يتعين الآن ان نواجه خصمين. الاول دولة عاتية، بخوذة ام بعمامة مستترة. والثاني ربيب هذه الدولة، او وكيـلهـا الطـوعي. الاول يستعرض عـضـلاته بـثـقة، والثاني يمـطـها من خـوف. وكلاهما أداة للـقـمـع الفكري.