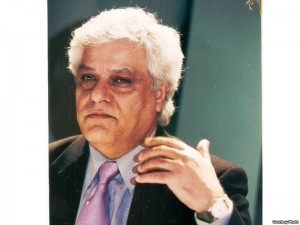تبدو الأمم المتحدة حتى اللحظة أقرب إلى نادٍ لهواة الخطابة: الكل يلهج بالقيم الكبرى، والكل يدوس عليها أو يوقرها عند الحاجة. فكرة أن الأمم، بالأحرى ممثليها، يبجلون القيم الكبرى لذاتها دائماً وأبداً، فكرة ساذجة بالطبع، فالمصالح تأتي أولاً، والقيم ثانيا،ً «الريال بوليتيكس» هي العماد. القيم تحظى بمقدار من الانتباه حين تفرض المصالح ذلك، وهي نادراً ما تفعل، أو حين يخرق أحد المبغوضين القِيَم يندفع الخصوم إلى أن يعتمروا عمامة الواعظ الورع المحتدم غيظاً من التجاوز.
في القاعة الكبرى ثمة سائر الأمم، المترف منها والمعوز. وفي القاعة الصغرى ثمة الخمسة الكبار، الأقوياء، الأثرياء، الجالسون على الكراسي الدائمة مثل المستبدين العرب، مع عشرة من الصغار ينعمون بصحبة الجبابرة لدورة واحدة، ينصتون في خشوع لخطب ذوي الوقار، كما يرقبون في خنوع انهيار آمالهم بارتفاع يد فيتو واحدة.
قبل عصر الإنترنت كنا نقرأ خبراً عما يدور أو نرى لقطات عابرة، اليوم علينا أن ننصت إلى كل تفاصيل المشاحنات الكلامية.
المشاهد تبدو مملة رتيبة مكرورة، يجأر فيها المندوبون بكل ما يخطر على البال من شعارات وكليشيهات التآمر والسيادة والعمالة والقانون الدولي والدماء إلخ. تتكرر هذه المشاهد لا لشيء إلا لكي يطويها النسيان في الغد.
لم تكن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً ما أراده لها الحالمون بعالم متوازن منذ قرنين، أن تكون محكمة للرأي العام لا منبراً لموظفين لا يملكون أي تفويض من أممهم التي يلهجون باسمها.
فكرة الأمم المتحدة ولدت قبل قرنين تقريباً، عام 1790، على يد المفكر الألماني عمانوئيل كانط، في أطروحته: نحو سلام دائم، والعنوان كما يقول واضعه هو لافتة تتصدر مقبرة: الأموات يرقدون في سلام دائم، أما الأحياء ففي احتراب دائم. الفكرة هي أن الدولة مؤلفة من أفراد أحرارهم سيكونون وقود الحرب أو مادة السلام من حقهم الاختيار.
ومثلما أن الفرد يخضع لرقابة المجتمع ومساءلته إن خرق السلم الأهلي، فإن الدولة هي فرد في الأسرة العالمية ويجب لجم نزوعها للحرب وضبطها مثلما يضبط الأبوان الولد العاق أو الشقي. ولهذا الهدف أقترح إنشاء هيئة عالمية سميت اتحاد الشعوب أو الأمم. واقتضى السياسيين وفقهاء القانون نحو قرن ونصف قرن ليضعوا الفكرة موضع التطبيق بإنشاء عصبة الأمم التي انهارت في الثلاثينات من القرن المنصرم، تلتها الأمم المتحدة عام 1945، بعد أهوال الحرب العالمية الثانية التي حصدت أرواح أكثر من خمسين مليوناً.
المنتصرون الكبار خرجوا منها حاملين ما يشبه الحق الإقطاعي، حق البكورية، أو حق الليلة الأولى مع العذراوات يوم الزفاف.
نادي الخمسة الكبار مستمر في احتكار حق النقض الفيتو، وهم بالمنطوق الديموقراطي «غير منتخبين»، أما صغار العالم الثالث، وأكثرهم من حكومات غير منتخبة، فعليهم الصعود إلى مجلس الأمن عبر الانتخابات، وهذه واحدة من مفارقات مزرية في أكبر مؤسسة عالمية.
بحساب بسيط، يستطيع مندوب أميركي، أو فرنسي، أو بريطاني أو روسي، والآن أيضاً صيني، أن يلغي رغبات سبعة بلايين إنسان وآمالهم في هذه المعمورة، فهم محض أرقام لا قيمة لها، مجرد أشياء في هذا الكون، محض مواضيع للانفعال لا للفعل.
والفيتو يكاد أن يكون كاريكاتورياً في غالبية الأحيان: تأويل القانون الدولي بمقلوبه. ويقف في خدمة ذلك عشرات الجهابذة من فقهاء القانون الدولي لتحويل الساكن متحركاً وقلب الأسود أبيض.
رأينا مراراً قبضة المندوب الأميركي ترتفع حماية لآخر وأطول دولة احتلال في التاريخ المعاصر: إسرائيل. أما روسيا اليوم فقد تخلت عن التراث اللينيني في دعم حركات شعوب العالم الثالث، وانتقلت إلى خط حماية مصالح الأمن القومي الروسي، من دون أي اعتبار للتشوق الديموقراطي لدى شعوب المنطقة، يسعفها في ذلك الضعف المديد للتقاليد الديموقراطية في التاريخ الروسي، وهزال ديموقراطيتها الحالية.
هل يمكن القبول بأن تتحكم خمس دول بمصائر العالم؟ إن حق النقض في حاجة إلى أن يُنْقَض، فالظروف التي تأسس في ظلها لم تعد قائمة. وإذا كانت القوى الغربية الكبرى تلهج بالديموقراطية مبدأ للحياة المعاصرة، فالأولى أن يشيع هذا المبدأ في أهم منظمة تعنى بشؤون الحرب والسلم وأكبرها عنايتها بأمور البيئة والصحة وما شاكل. ليس بالوسع قبول استمرار هذا الوضع ولا بد من حركة احتجاج عالمية في هذا الاتجاه.
مسألة أخرى هي وجود عشرات الدول أعضاء في الجمعية العامة من دون أن تحظى هذه الدول برضا مجتمعاتها. فهي دول أو قل حكومات مستبدة، فاقدة شرعية التمثيل. حصلت سابقة واحدة هي نزع شرعية ليبيا القذافي، أو شرعية جنوب أفريقيا قبلها. هذه مسألة محورية، نظراً إلى أن كل محاولة لحمل الحكومات على الالتزام بالقانون الدولي تصطدم بمقولة السيادة التي تحولت إلى مسوغ لكل الانتهاكات. لقد ولدت فكرة السيادة قبل أربعة قرون أو أكثر لحماية المجال الوطني من موجات الاحتراب الديني، ومن تطفل الجيران، أما السيادة اليوم فتقوم على رضا الجماعة، الأمة، المجتمع، الأهالي، سمهم ما شئت. إن وجود مثل هذه الدول هو إهانة لفكرة الأمم المتحدة ومثالها ومبادئها وميثاقها.
ليس هذا تحليقاً في فضاء المثل العليا، فكرة الأمم المتحدة كانت لحظة ولادتها تحليقاً في المثال. المشكلة هي غياب أي تفكير جاد لحل المشكلة، وطرح السؤال المطلوب هو كما يقال نصف الحل.
لا يزال المجتمع البشري يضع قدماً في عالم الحضارة وأخرى في عالم الحيوان البهيمي، وإلا كيف نفسر هذا التلذذ بسفك دماء مَنْ عليك حمايتهم والذود عنهم، تلذذاً يبز خيال منشئ السادية.