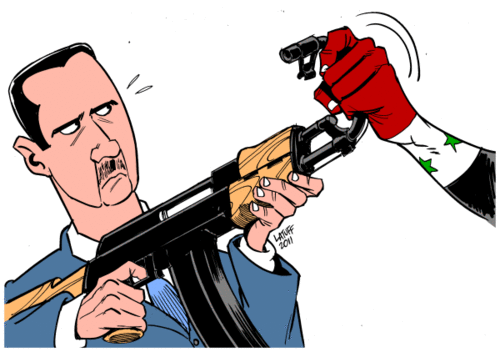والمعارضة في نهاية المطاف هي قدر كل حكومة وإدارة، فليس هناك حكومة ليس لها معارضة، بل لا توجد فكرة دون أن تنشأ لها فكرة نقيضة أو ناقدة.
لقد لجأ نظام صدام حسين في العراق إلى العنف ضد معارضيه فاضطرهم لتشكيل المليشيات واللجوء إلى دول معادية لنظامه كإيران وسوريا ثم الاستعانة بدول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا. رفض صدام كل الحلول السياسية والسلمية للمشكلة العراقية وكان آخرها مبادرة المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة، التي طالبت بتنحيته وعائلته عن السلطة والسماح بانتقالها سلمياً إلى حكومة أخرى. كان يمكن أن تنقذ تلك المبادرة العراق من الأخطار التي تعرض لها لاحقاً لو أن النظام قبل بها، لكنه رفضها كما رفض كل فكرة يمكن أن تقود إلى إبعاده عن السلطة.
كان صدام عنيفاً وقاسياً مع المعارضة فبادلته العنف والقسوة، مع التفاوت في الإمكانيات ونوع الأدوات المستخدمة، فالنظام امتلك أحدث أدوات الفتك الجماعي والتمرس في استخدامها، بينما لجأت المعارضة إلى الطرق التقليدية، والتفوق دائماً للنظام لأنه يمتلك المال والسلاح والتدريب والمعلومات الاستخبارية والشرعية الدولية.
النظام السوري مارس هو الآخر العنف بكل أشكاله مع معارضيه، ما دفعهم إلى حمل السلاح ضده والاستعانة بدول أخرى معادية له بالإضافة إلى الجماعات الجهادية المسلحة التي تريد أن تحارب أعداءها في كل مكان وهؤلاء يشكلون تقريباً معظم بني البشر. وكانت النتيجة تخريب سوريا وتعريض أهلها إلى القتل والتشريد والأذى مع بقاء النظام في السلطة، وهذا يشبه كثيراً ما حصل في العراق عام ١٩٩١ عندما فتك النظام بالمعارضة الشعبية بينما بقي في السلطة إثني عشر عاما أخرى حتى أطيح به من الخارج.
لكن العنف الذي حصل في العراق وليبيا، ويحصل حالياً في سوريا، لم يحصل في مصر في ظل نظام الرئيس حسني مبارك ولا في تونس في ظل نظام الرئيس زين العابدين بن علي، ولا في اليمن في ظل نظام الرئيس علي عبد الله صالح. لذلك كانت المعارضة لتلك الأنظمة سلمية نسبياً ولم تتسبب الثورات المصرية والتونسية واليمنية ضد الأنظمة الحاكمة بإلحاق أضرار كبيرة، مادية أو بشرية، في بنية الدولة والمجتمع في البلدان الثلاثة. والسبب هو أن تلك الأنظمة سمحت بقدر من حرية التعبير والعمل السياسي، رغم أن تلك الفسحة لم تكن مُرْضِية للمعارضة لأنها لم تفِ بالحد الأدنى لمطالبها وهو المشاركة الفعلية في السلطة.
ليس هذا استحساناً لأنظمة دكتاتورية حرمت شعوبها من المشاركة السياسية ودفعتها إلى الثورة ضدها والإطاحة بها، بل هو مجرد توصيف ومقارنة مع ما حصل ويحصل في دول عربية أخرى. وهو يشكل دليلاً على أن الإسلاميين ليسوا جميعاً مجبولين على العنف ولا يلجؤون دائماً إلى التمرد المسلح إن كان بإمكانهم ممارسة العمل السياسي والتعبير عن آرائهم بحرية. وهذا لا ينكر وجود فكر ديني إقصائي متطرف لا يقبل مطلقاً بالتعايش مع الآخر المختلف بل يصر على اجتثاثه من جذوره باسم الله. لكن هذا الفكر الذي تؤمن به الجماعات المسلحة هو فكر تدميري لا يمتلك مقومات البقاء لأنه يسعى لتحقيق أمر مستحيل ألا وهو إلغاء الاختلاف كلياً وهذا عادة ما يقود إلى الاحتراب بين الجماعات أنفسها.
لقد تعايش الإسلاميون المعتدلون مع الأنظمة الحاكمة في بلدان كثيرة، منها تركيا وباكستان ومصر والأردن، ولم يعلنوا الحرب عليها كما فعلوا في سوريا، لأنها سمحت لهم بقدر معقول من حرية الرأي والعمل، ولأن رموزها المتنفذين لا يختلفون عنهم مذهبياً، فلم يتولد لديهم شعور بالتمييز الطائفي.
الأنظمة الدكتاتورية ذات الطبيعة القمعية هي التي تدفع بمعارضيها إلى التشدد وهذا ما دفع العراقيين والسوريين إلى إعلان الحرب ضد نظامي البعث في البلدين، وما زاد من عدم انسجامهم مع النظامين هو انتماء الفئة الحاكمة إلى فئة الأقلية ما سهَّل إلقاء اللوم على أبناء تلك الفئة جميعاً، وأدى إلى نشوء وتعزيز الطائفية في البلدين.
من حق العلمانيين والقوميين والمتدينين المعتدلين وغير المتشددين بالإضافة إلى غير المسلمين والطوائف غير السنية في سوريا وباقي بلدان العالم العربي أن يقلقوا من المصير الذي سيلاقيهم إن تولى الحكم متطرفون يسيرون على منهج تنظيم القاعدة الإقصائي أو يدينون بالولاء أو الفضل له. لا أحد ينكر أن صلاحية النظام السوري قد انتهت منذ زمن بعيد، إلا إن البديل المحتمل لهذا النظام يرعب الكثيرين من السوريين وجيرانهم والعالم أجمع.
النظام السوري يرفض المعارضة لأنه يعتبر نفسه الأحق بالحكم والأصلح له والأقدر عليه بينما يعتبر منافسيه جميعا خارجين على الشرعية والقانون والأخلاق والمصلحة الوطنية والقومية. مثل هذا النظام سيزول دون شك ولكن القلق المحلي والاقليمي والدولي سيبقى حتى يتبين أن متطرفي القاعدة والنصرة وغيرهما من الجماعات الإقصائية لن يكون لهم مكان في سوريا.