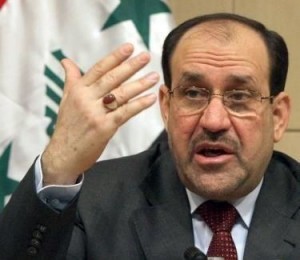إنها مجالس إسناد المالكي
الحياة اللندنية: 2009-01-06
مجالس الإسناد التي أنشأها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذا العام، وسط وجنوب العراق، والتي أثارت مخاوف خصومه السياسيين جميعا، لم تُنشأ خارج الدستور كما ادعى مناوئوه، ولم تكن لها ضرورةٌ أمنية كما ادعى السيد المالكي، بل هي تحرك سياسي طبيعي لكسب الأنصار في ساحة سياسية ملتهبة ومليئة بالمتنافسين الذين لم يترددوا في السابق في استخدام كل الأسلحة المتاحة بما فيها التأجيج الطائفي أو القومي. إلا أن هذه الساحة الشعبية التي يتحرك فيها المالكي، دائما ما تفضل من في السلطة على من هو خارجها.
وأول من عارض تحرك المالكي هذا شركاؤه ومنافسوه في كتلة الإئتلاف وخصوصا المجلس الأعلى، الذي رأى في تحركه باتجاه العشائر في الجنوب تهديدا خاصا لنفوذه في هذه الساحة التي يعتبرها حكرا له. لكن المالكي، الذي اصطدم بحقيقة أن حزب الدعوة الذي يتزعمه، ليس حزبا سياسيا بالمعنى المألوف وإنما بمثابة جمعية لها أهداف بعيدة الأمد قد تتفق أو تختلف مع توجهات سياسية معينة، لكنه ليس مؤهلا لأن يشكل ذراعا سياسيا قادرا على دعم حكومته كما تفعل الأحزاب الأخرى المنافسة له، على الأقل نظريا.
فالحزب الذي أسسه مجموعة من رجال الدين في الخمسينات، كان هدفه الأساس نشر الوعي الديني بين الشيعة تحديدا في مواجهة الأفكار العلمانية اليسارية والقومية، وتقديم البديل الشيعي لحركة الإخوان المسلمين وحزب التحرير السنييّن، ولم يكن ضمن أولوياته أو أهدافه تسلم السلطة، بل تغيير المجتمع الشيعي على نحو تدريجي طويل. وفي حوار شخصي مع زعيمه السابق، إبراهيم الجعفري، قال لي إن «حزب الدعوة ليس حزبا سياسيا بالمعنى المعروف بل هو حزب إصلاح اجتماعي له أهداف سياسية». بينما طالب أحد قيادييه السابقين، وهو الشيخ ضياء الشكرجي، في مقال له، بفصل أهداف الحزب السياسية عن الدينية التي قال إنها يجب أن تترك لجمعية خيرية أو منظمة مجتمع مدني.
وهذه مشكلة حزب الدعوة الأزلية التي قادت إلى انشقاقات كثيرة وخطيرة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، كان أولها الإنشقاق الذي قاده المرحوم عزالدين سليم عام 1983، تحت اسم «حركة الدعوة الإسلامية» ثم تلاه إنشقاق محمد عبد الجبار الذي شكل «كوادر الدعوة الإسلامية» عام 1991 ثم هاشم الموسوي (أبو عقيل) عام 1999 والذي أسس حزبا آخر بنفس الاسم مع إضافة لاحقة «تنظيم العراق» إليه، والذي يتحالف حاليا مع المالكي. ثم الانشقاق الذي قاده مازن مكية عام 2005 الذي أسس حزبا جديدا باسم «أنصار الدعوة»، أما آخر إنشقاق فكان بقيادة زعيم الحزب السابق إبراهيم الجعفري، منتصف 2007، باسم «تيار الإصلاح الوطني».
والجعفري أدرك، ربما متأخرا، أن الحزب السياسي يجب أن يكون منفتحا أمام جميع أفراد الشعب، بغض النظر عن المذهب أو درجة الالتزام الديني، كي ينضم إليه من يشاء من الناس ممن يتفاعل مع برنامجه السياسي، لا أن يستهدف نخبة صغيرة من الدعاة يعمل من خلالها على تغيير قناعات الناس الدينية أو التاريخية، فهذا ليس شأنا يضطلع به الحزب السياسي. وبسبب كثرة الانشقاقات اضطر المالكي للجوء إلى القضاء مؤخرا كي يمنع المنشقين من استخدام اسم «الدعوة» في أحزابهم الجديدة، مستثنيا «تنظيم العراق» من هذه الدعوى القضائية التي كسبها. ثم، هناك مئات الأشخاص من القيادات والكوادر الذين غادروا الحزب، ومنهم قياديون كبار كعلي التميمي وسامي العسكري وموفـــق الربيعي وضياء الشكرجي والشيخ محمد مهدي الآصفي. فمشكلة المالكي أنه وجد نفسه وحزبه في سلطة تعتمد، ولو شكليا، على تأييد الناس وتصويتهم في الانتخابات، وأن حزبه ليس قادرا على الانفتاح على الناس وضم الراغبين إلى صفوفه لأنه مصمَّم أساسا لنخبة قليلة من المبلِّغين الدينيين.
لم يعترض السياسيون الأكراد ولا قادة المجلس الأعلى الإسلامي على إنشاء مجالس الصحوة في محافظة الأنبار، المماثلة لمجالس الإسناد في الجنوب، بل أيدوها بقوة لأنها قوضت نفوذ منظمة القاعدة المعادية، وعززت سلطة النظام الجديد، بل كان المالكي نفسه من عارضها بسبب خشيته من أن تشكل تهديدا لسلطته، وقد اصطدم مع حلفائه الأميركيين حول هذا الأمر تحديدا لكنه رضخ في نهاية المطاف، وبعد أن رأى أنها يمكن أن تكون حليفا له ومنافسا قويا لمنافسيه في جبهة التوافق السنية، فاستجاب للطلب الأميركي بضمها إلى الجيش أو الشرطة، بل استخدمها كورقة ضد خصومه في جبهة التوافق، وهدد بأنه سيستعيض عنها بمجالس الصحوة كممثلين للسنة في الحكومة إن لم توافق على العودة إلى حكومته.
وقد عادت التوافق مضطرة دون أن تحقق أيا من أهدافها. وتأتي مبادرة طارق الهاشمي بالتخلي عن المحاصصة الطائفية في إطار كسب زمام المبادرة التي فقدها للمالكي الذي تمكن، بدعم أميركي غير محدود، من تحقيق نجاحات على الصعيدين الأمني والسياسي، خصوصا تمكنه من إبرام الاتفاقية الأمنية. ومبادرة الهاشمي كانت لتحقق نصرا كبيرا وتهدم نظام المحاصصة إن هو أقدم فعلا على تنفيذها دون شروط، وسوف نرى بعد الانتخابات المقبلة إن كان حزبه وحلفاؤه سيتصرفون بعيدا عن المحاصصة، خصوصا بعد أن تنتهي فترة التوافق السياسي الحالية دستوريا.
في كل الأحوال فالكثير من السياسيين الآن تخلوا عن مواقفهم الطائفية السابقة، أو تظاهروا بذلك، بسبب رفض معظم العراقيين للطائفية السياسية. إلا أنه، ورغم ذلك، لا يمكن استبعاد سلاح الطائفية كليا من المعارك السياسية المقبلة. والخلافات المثارة حول مجالس الإسناد سياسية بحتة وإن أطّرها المتخاصمون بأطر الدستور أو الأمن. فليس هناك ضرورة أمنية لمجالس الإسناد كما كانت لمجالس الصحوة في المناطق الغربية، لأن الجنوب ليست فيه مشكلة أمنية، وإن وجدت فإن هذه المجالس لن تستطيع أن تحقق الأمن أو تهزم المجموعات المسلحة خصوصا وأنها مجردة من المال والسلاح كما يقول المالكي.
وفي الوقت نفسه فإن إنشاءها، مهما كانت أسبابه، لن يشكل مخالفة دستورية، فالدستور لا يمنع إقامة الكيانات السياسية أو الاجتماعية، وإلا لشكّل ذلك عائقا أمام تأسيس «المجلس السياسي للأمن الوطني» الذي يضم قادة الكتل البرلمانية، أو «المجلس التنفيذي» الذي يضم رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس إقليم كردستان. فإنشاء مجالس الإسناد يدخل ضمن صلاحيات الحكومة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وضمن التحرك السياسي المشروع لكسب الأنصار، وهذا ما يمارسه السياسيون جميعا، في السلطة أو خارجها. إنها حقا مجاس إسناد المالكي.
* كاتب عراقي.