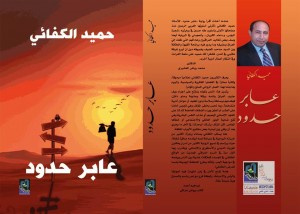ضياء الشكرجي- جريدة المدى- 19/9/2014
كنت قد انتهيت في التاسع عشر من آب من قراءتي لرواية «عابر حدود»، وما أن انتهيت من قراءتها، حتى كتبت للصديق مؤلف الرواية أشكره على ما أمتعني به في روايته، متداركا ذلك بقولي له: أقول «رغم أنك آذيتني»، وسأبين لماذا أمتَعَتْني، وآذتْني الرواية، في آن. في البدء، لا بد من التعبير عن تفاعلي مع هذه الرواية، التي وجدتها أكثر من رائعة.
وكنت حال فراغي من قراءتها قد سارعت بكتابة رسالة للمؤلف معبرا له عن انطباعاتي، ثم رأيت أن أحول مضامين الرسالة إلى مقالة، مع تأكيدي بأني لست ناقدا أدبيا، ولذا كتبت انطباعاتي كقارئ.
عندما وصلتني النسخة الورقية من الكتاب، لم أبادر بفتح الكتاب والمباشرة بقراءته، فور وصوله، وهو عندي يتعارض مع شكر الهدية، إذ لا يكون الشكر على هدية، أيا كانت، إلا بمنحها الاهتمام الذي تستحق، وإن كان التأخر بقراءتها لا يعبر عن عدم اهتمام من حيث القصد، بل من حيث الفعل. مع هذا وجدتني معذورا، لأني منهمك بأمور كثيرة، مزدحمة ومتداخلة، ومنها الإعداد والاشتغال على أكثر من كتاب بالعربية والألمانية، ثم إني وللأسف قارئ كسول.
لكن جاءت لحسن الحظ الفرصة، إذ حصل لي سفر بالقطار من هامبورغ إلى برلين، والقطار يكون بالنسبة لي دائما فرصة للمطالعة. ولم أكن بحاجة للتفكير فيما عليّ أن آخذ معي للمطالعة، فكتاب صديقي وهديته كانت تنتظرني منذ وصولها مرسلة منه بالبريد، كما كنت أنتظر فرصة الولوج في عالمها.
كنت أتمنى، وأنا أقرأ الكتاب، أن يكون معي ما أكتب به ملاحظاتي وانطباعاتي، لكن هذا يعكر صفو مواصلة القراءة بسلاسة، التي تتطلب عدم التوقف عن تتبع أحداث الرواية، بل ملاحقتها بالتتابع. قرأت جزءاً منها في طريق السفر إلى برلين، وقسما في طريق العودة، مع هذا لم أنتهِ من الكتاب، لأنه حصل تقطع في القراءة، ولأني، كما ذكرت، وهذا عيبي، قارئٌ كسول، وإن كنت شغوفا في قراءة ما أنجذب إليه، وأتفاعل معه، كما الحال مع «عابر حدود».
وصلت يومئذ البيت مساءً، ولم أُتمم قراءة الرواية إلى نهايتها. وقبل أن أواصل سرد كيفية انتهائي من قراءتها، أحب أن أسجل بعض انطباعاتي. طبعا، وكما بينت، أنا لست ناقدا أدبيا، ولا خبرة لي بالنقد والتقييم (التقويم)، لكن مع هذا دعوني أحدثكم عن انطباعاتي عن الرواية كقارئ.
هناك تنوع في البيئات التي تنقلت فيها الرواية، السدير، الرميثة، بغداد. هناك تقاليد وأعراف عشائرية، وهناك انفتاح وحداثة في المدينة. طبعا هي حداثة ومدنية وتحرر بغداد آنذاك، أي قبل عهد جاهلية التأسلم، بل نجد الانفتاح النسبي حتى في الرميثة. في الرواية نقد ضمني للتقاليد، نقد للمفهوم الشعبي للدين، وبعض ممارسات المتدينين. فيها قيم أخلاقية، فيها فلسفة حياة، فيها مفاهيم اجتماعية وسياسية، قدمها كاتب الرواية بانسيابية، دون أن يُشعِر القارئ بأنه يريد أن يكون واعظا أخلاقيا، أو مفلسفا للحياة، أو ذا فهم سياسي وثقافي ما، وهنا تكمن قيمة الفن، ولكون الرواية بتقديري، هي لون من ألوان الفن، أكثر من كونها لونا من ألوان الأدب، أو هو فن بأدوات الأدب.
كما يجد القارئ في سياحته في «عابر حدود» تنوعا في الشخصيات، الأمية منها، والمتعلمة، الخبيثة، والطيبة، المحافظة والمتمردة. إنها، أي الرواية، سياحة في مجالات متعددة، تنتقل بالقارئ بانسيابية وعفوية من عالم إلى آخر. طبعا هناك الكثير مما يمكن أن يقال، وكثير منه كان يراودني أثناء قراءتي، وكثير منه نسيته. ولو توفر لي الوقت لأعدت قراءتها وسجلت انطباعاتي أثناء القراءة، وهكذا لو كانت ذاكرتي أشد اتقادا مما هي عليه، لكان ذلك أنفع، ولكن ما لا يُبلغ أقصى مداه، فجميل أن يبلغ ما هو ممكن منه.
ذكرت عندما رجعت إلى البيت مساء ذلك اليوم، وأنا لم أكمل قراءة الرواية إلى نهايتها. وبالرغم من شوقي الشديد لمتابعة السياحة مع أحداثها، انشغلت عنها ليومين، ثم عدت إلى الكتاب ثانية. وكان بالإمكان، من حيث الوقت، وبلحاظ الشوق لملاحقة بقية أحداث الرواية، قراءته إلى نهايته. لكني عندما وصلت إلى الصفحة 172، وكم آذتني الصفحة 172، لم أرد أن أواصل. وكأني أخاطب كاتب الرواية، أن اعذرني، فقد كرهت الرواية بقدر ما أحببتها، لأن الصفحة 172 ولّدت عندي مخاوف، لم أرد أن أواجهها. فإنني كصبي في بدايات ارتيادي السينما برفقة الكبار، ثم كمراهق وشاب في بدايات شبابي، كانت السينما أهم مجالات الترفيه، كما عند الكثيرين من العراقيين في الخمسينات والستينات. وكنت أشعر بضيق عندما ينتهي الفلم بنهاية غير سعيدة، فالنهاية الكئيبة كانت تحدث عندي كآبة، ربما لا تفارقني لأيام، بحسب ما لذلك الفلم وقصته من تأثير على المشاهد، وعليّ بالذات، لاسيما فيما هو التأثير العاطفي.
فمثلا النهاية الكارثية لفلم سكَارتاكوس ببطولة كيرك دوكَلاس وجين سيمونس وتوني كیرتس، عاشت معي لفترة طويلة، وهكذا هو الحال مع أفلام الحب، التي لا تنتهي بنهاية سعيدة، كفلم Love Story، إذ بقيت دائما أحب أن تنتهي الأفلام بنهاية سعيدة (happy end). والصفحة 172 أنبأتني أن رواية صديقي الكفائي لن تنتهي بـ (happy end)، على الأقل ليس لجميع أبطال الرواية، لاسيما لسعاد التي تعاطفت معها كثيرا، وأحببتها واحترمتها. منذ عبارة «أخبره البواب أن مُراجِعةً في الوزارة أصرت على مقابلة المدير العام»، صاح قلبي موجوعا «يا ساتر»، فورّقت الكتاب إلى نهايته سريعا دون أن أقرأ، إلا بضع كلمات ألتقطها من هنا وهناك، لاسيما على الصفحة 192 (الأخيرة)، هاربا من قراءة المزيد، فيما فيه تفصيل لما أخشاه. فعلمت بالنهاية. نقمت على الكتاب اللذيذ، لأنه لم يلبِّ رغبتي بأن يقدم لي (happy end).
تركت الكتاب جانبا، دون أن أقرأ العشرين صفحة الأخيرة. لكن بعد يومين أو لعلها ثلاثة أيام، وقعت عيناي على هدية صديقي كاتب «عابر حدود» الجميلة، فاستجمعت شجاعتي في مواجهة الواقع المرّ للنهاية غير السعيدة، على الأقل بنسبة لسعاد التي أحببتها واحترمتها، وقررت أن أقرأ ما تبقى من صفحات الكتاب.
على خلاف عادتي، أخذت أقرأ مسرعا، وأخذت تتصاعد سرعة القراءة، كمن هو محكوم عليه بالإعدام، ويريد أن يسرع إلى النهاية المحتمة، حتى يتخلص من عذاب التفكير بالنهاية المحزنة والمرعبة. وفعلا كانت النهاية كما توقعت. إذ ترك صالح زوجته سعاد وطفليهما، رغم كل الحب الذي كان يربط بين صالح وسعاد، ورغم كل حبه لطفليهما، ورغم كل السعادة التي كانت هذه الأسرة تغبط عليها من المحبين، وتحسد عليها من الحاسدين، واختار أن ينقاد لأوامر قلبه، الذي تجددت فيه نبضات حبه الكبير القديم لهالة، تلك المرأة الفاتنة والجريئة والعابرة لكل حدود التقاليد والدين، وصاحبة الإرادة المعاندة التي لا تقهر، أو هكذا تريدها، في أن تصنع كل ما تريد، والتي بسبب هذه الإرادة، تركت صالح لسنوات لتستمتع بحريتها بلا حدود في أوروپا، وتكمل دراستها العليا، حيث يئس صالح من عودتها، وعاش سني بؤس الفراق وتعاسة هجران الحبيب. ثم عادت، وهو في ذروة سعادته مع أسرته، لتختطفه من زوجته الحبيبة وطفليه الغاليين، لتخطفه منهم لنفسها من جديد، ولتجعله يعبر معها، متحديين كل الحدود من تقاليد وأعراف.
لكني لم أتوقف عند نهاية الرواية، بل تصورت تكملة الرواية ما بعد الصفحة 192، أي تكملة ما لم يكتبه الكفائي. فرأيت إن هالة ستلفظ يوما صالح ثانية. صحيح إنها مجنونة في حبها له، لكنها مجنونة أيضا في الانطلاق في حريتها إلى ما لا حدود، ومجنونة كذلك بتنفيذ إراداتها ورغباتها، متى ما أرادت شيئا أو رغبت فيه، كما هي مجنونة بالتضحية بأحب ما تحبه ومن تحبه، إن وجدت ما هو أحب، أو لعله ما هو بتقديرها أهم، حتى لو لم يكن الأحب. فهالة أحبت صالح حبا جنونيا، لكن في تشخيصي لها من موقع حبها الجنوني لنفسها ولحريتها. ولذا فالحبيب حبيب، طالما لم ينافسها مع حبها لنفسها، أو يتقاطع ذلك الحب، أو مع إراداتها التي لا حدود لها.
أحببت واحترمت هالة من جهة، لأنها عابرة حدود بامتياز، ولأني أحب عابري الحدود، عابري حدود التقاليد، وعابري حدود الدين، ولكني لا أحب عابري حدود الضمير. فمثلما عرفت هالة تفاصيل عمل صالح بعد عودتها من أوروپا بعد كل تلك السنوات، فلا بد إنها علمت أنه متزوج وسعيد بزواجه، وإنه تزوج عن حب، وله طفلان يضفيان على البيت السعيد مزيدا من السعادة. فكيف سمح لها ضميرها أن تقتل سعاد، تقتل سعادتها، تقتل أحلامها، من أجل حبها الأناني، وهل يلتقي الحب مع الأنانية؟ سؤال أحب أن أوجهه إلى هالة، لو كتب لي أن ألتقي بها.
أرجع وأقول، الكتاب ليس مجرد رواية، إنه ممتلئ، ممتلئ، ممتلئ بمفاهيم، عادات، فلسفة، قيم، علم اجتماع، رؤى نقدية، فولكلور، ثورة، تمرد، عبور، أخلاقيات، …، ….
فشكرا لكاتب «عابر حدود»، الذي أمتعني، بقدر ما آذاني، وعبر معي، وعبرت معه، ثم توقفت عند عبور واحد، وامتنعت عنه. لكن هكذا هي الحياة، ليس من متعة إلا ولها منغصات، ولذا فإن قوة الرواية إنها قد كتبت من واقع الحياة، ولم تكتب من موقع أحلام أمثالي، فيما نحب للحياة أن تكون. وليعذرني كاتب «عابر حدود»، إذ لم أعرف عنه روائيا مبدعا، إلا بعد قراءتي «عابر حدود».
http://www.almadapaper.net/ar/news/471323/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A